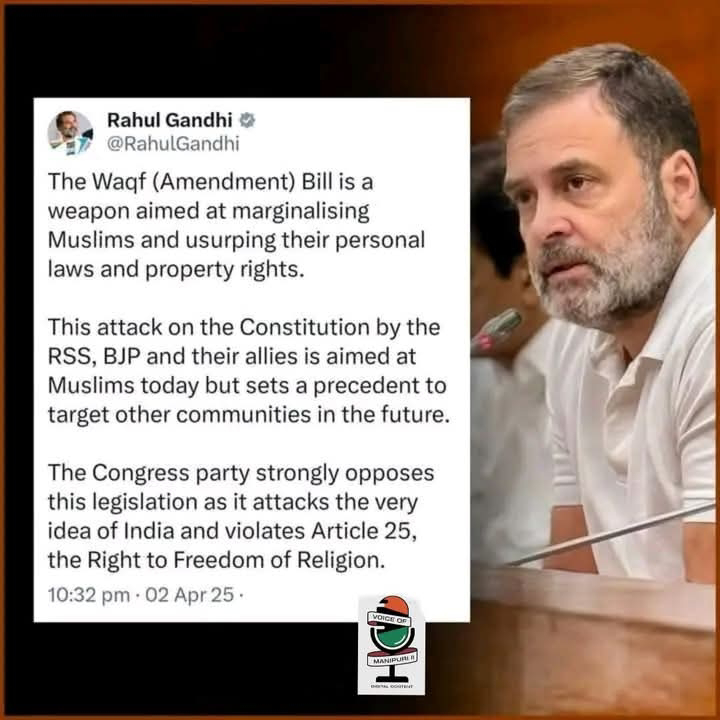في الوقت الذي تواجه فيه العديد من الدول النامية تحديات مالية كبيرة في مجال البحث والتطوير، ظهرت مبادرة مبتكرة تستهدف إحياء صناعة الطيران الوطنية دون تحميل الدولة أعباءً مالية ضخمة. المبادرة تقوم على إطلاق مسابقات وطنية بين أساتذة الجامعات الحكومية لتصميم نماذج طائرات ومروحيات وطائرات مُسيّرة، بحيث يحصل أصحاب التصميمات القابلة للتطبيق على دعمٍ تقني وفرصة لقيادة مراحل تطوير المشروع.
وتسعى الفكرة إلى تحويل الجامعات من مؤسسات تعليمية بحتة إلى مصانع أفكار وطنية، تشارك بشكل مباشر في بناء القدرات الدفاعية والتكنولوجية. وبموجب المبادرة، يحصل صاحب التصميم الأفضل على منصب عميد كلية الهندسة في جامعته، بينما يُرشح الفريق الذي ينجح في تصنيع نموذج أولي عملي لمنصب أعلى أكاديمي مثل رئاسة الجامعة. هذا الحافز الأكاديمي يمنح بُعداً جديداً لروح المنافسة العلمية.
الفكرة لا تتوقف عند حدود المنافسة، بل تؤسس لمنظومة تكامل بين الجامعات ومراكز البحث والصناعة الوطنية. حيث يجري توفير خبراء في ديناميكا الهواء، والمحركات، والإلكترونيات، والذكاء الاصطناعي لدعم التصميمات التي تثبت جدواها في المراحل الأولية. ويُسمح للفرق بالاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل النماذج وحسابات الإجهاد والمحاكاة الافتراضية.
هذه المبادرة لا تعتمد على ميزانيات ضخمة، بل على استثمار العقول الوطنية، وهو ما يجعلها نموذجاً اقتصادياً فعالاً. فبدلاً من التعاقد مع شركات أجنبية بتكاليف باهظة، تسعى الدولة إلى خلق منتجات محلية من خلال خبراءها الداخليين. كما تمنح الكفاءات الأكاديمية فرصة لإثبات قدراتها عملياً، وليس فقط نظرياً، ما يرفع مستوى التعليم الهندسي ويعزز القيمة العلمية للجامعات.
اللافت في البرنامج أنه يعزز ثقافة الاعتماد على الذات في القطاعات الاستراتيجية مثل الطيران العسكري والطائرات بدون طيار وطائرات النقل الخفيف. ويتيح إمكان تطوير نماذج مستقبلية لطائرات الإمالة الدوارة، والطائرات الهجينة الكهربائية، وحتى الطائرات القتالية الخفيفة.
وتتوقع الجهات الداعمة أن تنتج هذه المبادرة خلال سنوات قليلة نماذج أولية قادرة على خوض اختبارات الطيران، مما يفتح الباب لتأسيس شركات ناشئة في مجال صناعة الطيران، وزيادة فرص العمل للمهندسين الشباب، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
إذا نجحت التجربة، يمكن أن تتحول إلى قاعدة وطنية لبناء صناعة دفاعية متكاملة دون الحاجة لرؤوس أموال ضخمة أو استيراد تكنولوجيا جاهزة من الخارج. فالعقل المحلي أصبح اليوم قادراً على المنافسة في ظل تسارع التقنيات وتوفر منصات الذكاء الاصطناعي لدعم التطوير والتجربة.
إمكانية تطبيق النموذج في سوريا وأفغانستان
يمكن تطبيق هذه الفكرة بصورة فعالة في دول مثل سوريا وأفغانستان التي تعاني من نقص كبير في الموارد المالية لكنها تملك رأسمال بشري وطني مؤهّل في الهندسة والعلوم.
- الجامعات في البلدين تضم خبرات علمية لم تُستثمر بالشكل المطلوب.
- نموذج المسابقة والتحفيز الأكاديمي يناسب ظروف ما بعد الحرب.
- لا يحتاج المشروع لميزانية حكومية كبيرة؛ بل يعتمد على العقول.
- يمكن للحكومة أو القطاع الخاص تقديم دعم رمزي للطباعة ثلاثية الأبعاد والمحاكاة.
- الذكاء الاصطناعي اليوم يغني عن الكثير من التكلفة الهندسية.
- النجاح الأولي يمكن أن يجذب التمويل الدولي للمشاريع المدنية والطائرات الخفيفة والدفاعية.
هذا النموذج قد يشكل طريقاً لإحياء الصناعات الوطنية بعد الحروب، ويمنح الأكاديميين فرصة لبناء مشاريع تكنولوجية استراتيجية دون الهجرة أو الاعتماد الكامل على الخارج.